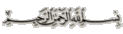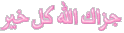محمد ديب نصف قرن من الابداع
محمد ديب نصف قرن من الابداع
الأحد 3 مايو - 19:09
بين تاريخ ميلاد محمد ديب 21/7/1920وتاريخ ميلاده الأدبي 1952 أو قبل ذلك بأربع سنوات 1948حينما شرع بتوقيع أولى قصائده، مسار حافل بالتجارب الإنسانية الغنية المأساوية منها والسعيدة و القريبة من ذلك. وتلك التجارب كان لها الأثر البالغ في إبداعه فيما بعد.
دخل محمد ديب المدرسة في سن السادسة، وفي الحادية عشرة من عمره توفي أبوه الذي لم يترك للعائلة من ثروة سوى عبرة دائمة التحفز: الفقر بعدما ذاقت العائلة رغدالعيش ويسر ذات الحال. ومع ذلك واصل ديب تعليمه الابتدائي والثانوي بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى مدينة وجدة شرقي المغرب الأقصى، وفي 1939 صار معلما في إحدى المدارس بقرية «زوج بغال» بالغرب الجزائري، وفي 1942 انتقل للعمل في السكك الحديدية،
ثم عمل محاسبا ثم مترجما (فرنسية ـ إنجليزية) في جيش الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية، ثم مصمما لموتيفات الزرابي بين 1945 و1947) عند بعض من معارفه من حرفيي النسيج بتلمسا. في 1948 انتقل إلى الجزائر العاصمة حيث التقى الأدباء: ألبير كامو، ومولود فرعون، وجان سيناك، وفي 1950 التحق بجريدة «الجزائر الجمهورية» ليجد نفسه إلى جانب كاتب ياسين صاحب رائعة نجمة 1956.
وبالموازاة مع ذلك شرع بنشر بعض من المساهمات الصحفية بجريدة «الحرية» لسان حال الحزب الشيوعي الجزائري. كتابات ديب الصحفية لم تكن مهادنة للاستعمار بالمرة.
فقد فتح بقلمه جبهة صراع صريح ومباشر مع المستعمر. مما جعل الأنظار تصوب إليه من اتجاهات عدة. فكانت أول صداماته مع البوليس الفرنسي الذي وجد في كتاباته «وطنية تتعدى الحدود». وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الاستعمارية آنئذ إلى قطع صلته بالجزائر فقررت طردته من وطنه بعد اتهامه «تجاور خطوط الاستعمار الحمراء والانتماء إلى «الفلاقة». وهكذا رحل محمد ديب إلى منفاه الاختياري متنقلا بين عواصم أوروبا الشرقية وروما وباريس، ثم المغرب الأقصى حيث أقام مدة قصيرة عام 1960. ومع استقلال الجزائر في 1962 عاد ديب إلى حضن الوطن فأصدر رواية «من يذكر البحر؟» وفي 1963 نال الأديب جائزة الدولة التقديرية للآداب رفقة الشاعر محمد العيد آل خليفة.
ثلاثية للجزائر وأخرى للمساء، الثورة وثالثة للشمال..
شهدت الجزائر إذن، ميلاد ديب الروائي في 1952، وبالتحديد، حينما أصدر روايته الأولى «البيت الكبير» عن دار «لوسوي» الفرنسية. الرواية لقيت نجاحا كبيرا؛ حيث نفدت طبعتها الأولى في مدة لم تتعد الشهر الواحد، لتتلوها الطبعة الثانية، وفي1954 كانت الرواية الثانية من «ثلاثية الجزائر»: «الحريق» التي بشرت بالثورة قبل أقل من ثلاثة أشهر من اشتعال شرارتها الأولى في الفاتح من نوفمبر 1954 وفي 1957 يكمل الثلاثية بإصداره رواية «النول». وفي الفترة مابين 1970 و1977 كتب ثلاث روايات اعتبرها الناقد والأديب المغربي محمد برادة بمثابة ثلاثية أخرى «انبرى فيها الكاتب لمساءلة الثورة الجزائرية والتساؤل عن مستقبلها وهي: إلهوسط الوحشية 1970، وسيد القنص 1973، وهابيل. 1977 هذه تجربة ـ بتعبير برادة ـ «تكشف عن محاولة تركيبية على جانب كبير من الأهمية سواء على صعيد الموضوع أم على صعيد الشكل». ويتجلى ذلك بوضوح للقارئ من خلال مكوناتها البنيوية: تداول المنظورات السردية، والفضاءات المكانية والشخصيات والتيمات التي تتضافر مع العناصر الفنية التي تكوّن لحمتها أو تتولد عنها لتشع جماليا كما لم يحدث في أية تجربة روائية جزائرية من قبل.
والواقع أن هذا الانعطاف في الكتابة كان قد أشار إليه ديب في ذيل روايته «من يذكر البحر؟ 1962»حيث أعلن بصراحة عن تخليه عن أسلوب الكتابة الواقعية بعدما تبين له عجز هذا النهج عن«إنارة عتمات عصرنا بأضواء كاشفة»؛ حيث يقول ديب: «لا يمكن التعبير عن جبروت الشر عن طريق وصف المظاهر المألوفة. لأن مجاله هو الإنسان بأحلامه وهذيانه التي يغذيها بغير هدى، والتي سعيت أن أضفي عليها شكلا محددا».
ليعلن محمد ديب أن المرشد المطلق للفنان المعاصر هو لوحة «جيرنيكا» لبيكاسو الذي استطاع ـ في نظره ـ أن يضفي على الكوابيس التي تغذيه هو وغيره «وجها يعرفه الآن الجميع». «وربما لا نبعد عن الحقيقة إذا زعمنا أن نص «هابيل» هو بلورة لطريقة خاصة في الكتابة عند ديب من خلالها أنجز ثلاثيته الشمالية: «سطوح أورصول 1985» وإغفاءة حواء 1989 و«ثلوج المرمر 1990».
وهي الثلاثية حيث يرسم محمد ديب ـ بتعبير جانديجوـ علامات تذكر بجذوره وبما احتفظ به في الذاكرة. غير أن ذات المبدع فيه تعمل دوما على خلط المسالك والأزمنة أمامه.. لتنتهي الأمور في «سطح أورصول» إلى النسيان، وفي «إغفاءة حواء» إلى الجنون والغياب، وفي «ثلوج المرمر» إلى صوت منفرد: «إن المتكلم لا يعدو أن يكون إلا مجرد صوت . إنه لا يحيى إلا بداخل ذلك الصوت».
. إنه لا يحيى إلا بداخل ذلك الصوت».
توالت حلقات سلسلة إصدارات محمد ديب الإبداعية تتوزعها مختلف الأجناس الأدبية على مدى أكثر من نصف قرن، كاشفة عن تحكم قلما أن يصادف عند كاتب واحد. إلا أن ديب استسلم لسحر الحكي فلم يعد يكتب غير الرؤية ابتداء من العام 1995. وربما يكون الدافع لهذا الزهد الإبداعي رغبة عارمة في صب زخم الإبداع عنده في عمل واحد هو على يقين من أنه لن يتحقق أبدا. ومن هنا استمرار الكتابة مكثفة وحبلى بما لا يخطر على بال من العوالم وإغراءات القراءة.
و في المحصلة يَعد محمد ديب الآن أكثر من ثلاثين مؤلفا منها ثماني عشرة رواية آخرها: «إذا رغب الشيطان و«الشجرة ذات القيل 1998»، وخمسة دواوين شعرية آخرها: «آه لتكن الحياة 1987»! وأربع مجموعات قصصية آخرها:
«الليلة المتوحشة 1997» ، وثلاث مسرحيات آخرها: «ألف مرحى لمومس 1980»، إلى جانب العديد من الترجمات الأدبية إلى الفرنسية خاصة من اللغة الفنلندية التي استقر نهائيا بين أهليها اعتبارا من العام 1989. كما يعد محمد ديب عضوا نشطا في عدة ورشات وحلقات علمية في الجامعات الأوروبية والأمريكية تهتم بالأدب بصفة عامة والرواية المغاربية بصفة خاصة.

دخل محمد ديب المدرسة في سن السادسة، وفي الحادية عشرة من عمره توفي أبوه الذي لم يترك للعائلة من ثروة سوى عبرة دائمة التحفز: الفقر بعدما ذاقت العائلة رغدالعيش ويسر ذات الحال. ومع ذلك واصل ديب تعليمه الابتدائي والثانوي بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى مدينة وجدة شرقي المغرب الأقصى، وفي 1939 صار معلما في إحدى المدارس بقرية «زوج بغال» بالغرب الجزائري، وفي 1942 انتقل للعمل في السكك الحديدية،
ثم عمل محاسبا ثم مترجما (فرنسية ـ إنجليزية) في جيش الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية، ثم مصمما لموتيفات الزرابي بين 1945 و1947) عند بعض من معارفه من حرفيي النسيج بتلمسا. في 1948 انتقل إلى الجزائر العاصمة حيث التقى الأدباء: ألبير كامو، ومولود فرعون، وجان سيناك، وفي 1950 التحق بجريدة «الجزائر الجمهورية» ليجد نفسه إلى جانب كاتب ياسين صاحب رائعة نجمة 1956.
وبالموازاة مع ذلك شرع بنشر بعض من المساهمات الصحفية بجريدة «الحرية» لسان حال الحزب الشيوعي الجزائري. كتابات ديب الصحفية لم تكن مهادنة للاستعمار بالمرة.
فقد فتح بقلمه جبهة صراع صريح ومباشر مع المستعمر. مما جعل الأنظار تصوب إليه من اتجاهات عدة. فكانت أول صداماته مع البوليس الفرنسي الذي وجد في كتاباته «وطنية تتعدى الحدود». وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الاستعمارية آنئذ إلى قطع صلته بالجزائر فقررت طردته من وطنه بعد اتهامه «تجاور خطوط الاستعمار الحمراء والانتماء إلى «الفلاقة». وهكذا رحل محمد ديب إلى منفاه الاختياري متنقلا بين عواصم أوروبا الشرقية وروما وباريس، ثم المغرب الأقصى حيث أقام مدة قصيرة عام 1960. ومع استقلال الجزائر في 1962 عاد ديب إلى حضن الوطن فأصدر رواية «من يذكر البحر؟» وفي 1963 نال الأديب جائزة الدولة التقديرية للآداب رفقة الشاعر محمد العيد آل خليفة.
ثلاثية للجزائر وأخرى للمساء، الثورة وثالثة للشمال..
شهدت الجزائر إذن، ميلاد ديب الروائي في 1952، وبالتحديد، حينما أصدر روايته الأولى «البيت الكبير» عن دار «لوسوي» الفرنسية. الرواية لقيت نجاحا كبيرا؛ حيث نفدت طبعتها الأولى في مدة لم تتعد الشهر الواحد، لتتلوها الطبعة الثانية، وفي1954 كانت الرواية الثانية من «ثلاثية الجزائر»: «الحريق» التي بشرت بالثورة قبل أقل من ثلاثة أشهر من اشتعال شرارتها الأولى في الفاتح من نوفمبر 1954 وفي 1957 يكمل الثلاثية بإصداره رواية «النول». وفي الفترة مابين 1970 و1977 كتب ثلاث روايات اعتبرها الناقد والأديب المغربي محمد برادة بمثابة ثلاثية أخرى «انبرى فيها الكاتب لمساءلة الثورة الجزائرية والتساؤل عن مستقبلها وهي: إلهوسط الوحشية 1970، وسيد القنص 1973، وهابيل. 1977 هذه تجربة ـ بتعبير برادة ـ «تكشف عن محاولة تركيبية على جانب كبير من الأهمية سواء على صعيد الموضوع أم على صعيد الشكل». ويتجلى ذلك بوضوح للقارئ من خلال مكوناتها البنيوية: تداول المنظورات السردية، والفضاءات المكانية والشخصيات والتيمات التي تتضافر مع العناصر الفنية التي تكوّن لحمتها أو تتولد عنها لتشع جماليا كما لم يحدث في أية تجربة روائية جزائرية من قبل.
والواقع أن هذا الانعطاف في الكتابة كان قد أشار إليه ديب في ذيل روايته «من يذكر البحر؟ 1962»حيث أعلن بصراحة عن تخليه عن أسلوب الكتابة الواقعية بعدما تبين له عجز هذا النهج عن«إنارة عتمات عصرنا بأضواء كاشفة»؛ حيث يقول ديب: «لا يمكن التعبير عن جبروت الشر عن طريق وصف المظاهر المألوفة. لأن مجاله هو الإنسان بأحلامه وهذيانه التي يغذيها بغير هدى، والتي سعيت أن أضفي عليها شكلا محددا».
ليعلن محمد ديب أن المرشد المطلق للفنان المعاصر هو لوحة «جيرنيكا» لبيكاسو الذي استطاع ـ في نظره ـ أن يضفي على الكوابيس التي تغذيه هو وغيره «وجها يعرفه الآن الجميع». «وربما لا نبعد عن الحقيقة إذا زعمنا أن نص «هابيل» هو بلورة لطريقة خاصة في الكتابة عند ديب من خلالها أنجز ثلاثيته الشمالية: «سطوح أورصول 1985» وإغفاءة حواء 1989 و«ثلوج المرمر 1990».
وهي الثلاثية حيث يرسم محمد ديب ـ بتعبير جانديجوـ علامات تذكر بجذوره وبما احتفظ به في الذاكرة. غير أن ذات المبدع فيه تعمل دوما على خلط المسالك والأزمنة أمامه.. لتنتهي الأمور في «سطح أورصول» إلى النسيان، وفي «إغفاءة حواء» إلى الجنون والغياب، وفي «ثلوج المرمر» إلى صوت منفرد: «إن المتكلم لا يعدو أن يكون إلا مجرد صوت
 . إنه لا يحيى إلا بداخل ذلك الصوت».
. إنه لا يحيى إلا بداخل ذلك الصوت». توالت حلقات سلسلة إصدارات محمد ديب الإبداعية تتوزعها مختلف الأجناس الأدبية على مدى أكثر من نصف قرن، كاشفة عن تحكم قلما أن يصادف عند كاتب واحد. إلا أن ديب استسلم لسحر الحكي فلم يعد يكتب غير الرؤية ابتداء من العام 1995. وربما يكون الدافع لهذا الزهد الإبداعي رغبة عارمة في صب زخم الإبداع عنده في عمل واحد هو على يقين من أنه لن يتحقق أبدا. ومن هنا استمرار الكتابة مكثفة وحبلى بما لا يخطر على بال من العوالم وإغراءات القراءة.
و في المحصلة يَعد محمد ديب الآن أكثر من ثلاثين مؤلفا منها ثماني عشرة رواية آخرها: «إذا رغب الشيطان و«الشجرة ذات القيل 1998»، وخمسة دواوين شعرية آخرها: «آه لتكن الحياة 1987»! وأربع مجموعات قصصية آخرها:
«الليلة المتوحشة 1997» ، وثلاث مسرحيات آخرها: «ألف مرحى لمومس 1980»، إلى جانب العديد من الترجمات الأدبية إلى الفرنسية خاصة من اللغة الفنلندية التي استقر نهائيا بين أهليها اعتبارا من العام 1989. كما يعد محمد ديب عضوا نشطا في عدة ورشات وحلقات علمية في الجامعات الأوروبية والأمريكية تهتم بالأدب بصفة عامة والرواية المغاربية بصفة خاصة.

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى